في أرض شاسعة خالية تمامًا من أي شي، لم يكن هناك إلا سيارتين جيب مطفأة، سجادة كبيرة ذات نقوش فارسية يتقاسمها ٤ أشخاص، مساند للظهور المنهكة، وأكواب شاي أعد على الجمر؛ لا يضاهي حرارته إلا حرارة تلقّفي لحكايا «الزحوفي».
وهذا «الزحوفي»، عزيزي القارئ، هو أحد الأشخاص الضليعين بمجوعات النجوم السماوية وراوٍ متمكن لقصصها مع أهل الصحراء، والذي جمعتني بحكاياه، ليلة باردة، ظلماء لا ينيرها إلا نصف قمر، في أرض صحراوية بالغرابيل.
إن كنت محظوظًا من قبل وجالست شخص كـ «ماجد الزحوفي»، فستنهال على مسامعك الكثير من قصص النجوم الفلكية التي تكشف الكثير عن علاقة الإنسان الحميمية بالسماء منذ القدم، وعن خصابة خيالاته بالعالم الآخر الفوقي…ذلك البعيد حسيًا لكن القريب وجدانيًا في ذهنه وقلبه، لتصبح السماء في عينيه مرآة تعكس قصص الحب والحروب التي ضاقت بها صدور من على الأرض، كل القصص مدهشة بلا استثناء بغض النظر عن صحتها، كلها اضطرتني لأن أشهق مرة أو مرتان على الأقل بعد كل قصة أسمعها (حسنًا ربما أكون دراما كوين بعض الشيء)، إلا أن من أكثر القصص التي استوقفتني كثيرًا كانت قصة شعبية شائعة عن الشاعر «راشد الخلاوي» والذي يقال أنه عاش في القرن الثامن هجري.
الشاعر ولغز المخبأ
جرت العادة أن يورث العرب أسلحتهم لأبنائهم، وهذا ما كان متوقعًا من الشاعر والعالم بموضع النجوم وتحركاتها «راشد الخلاوي»، إلا أن ابنه كان بعد صغير، وقد شعر «الخلاوي» أن المنية ستلاقيه قبل أن يبلغ ابنه سن حمل السيف، فاتخذ مسلكًا يتأكد به من استحقاق ابنه للحصول على السلاح، فخبئه في مكان يصعب إيجاده.
وحين دنى موعد رحيل الشاعر من هذه الدنيا، لقّن زوجته أبيات تشير إلى المخبأ، لتلقيها بدورها على مسامع ابنهما حينما يأتي اليوم الذي يسأل فيه عن سلاح أبيه، وعندما حلّ ذلك اليوم أنشدت الزوجة الأبيات التالية:
عن طلحة الجودي تواقيم روحه
عليها شمالي النسور يغيبْ
وعنها مهبّ الهيف رجمٍ وفيضه
وحروري ان كان الدليل نجيبْ
وتقول القصة أن الابن بدأ بالعمل على حل هذا اللغز، وبعد حين وجد المخبأ..
ماذا لو تبنت الشركات والمؤسسات نهج «الخلاوي»؟
تزعم العديد من بيئات العمل أنها توظف بناء على الجدارات والأهلية، خاصة فيما يتعلق بالمناصب الإدارية والقيادية، وألتمس شخصيًا الجهود والتغيرات الحقيقية والإيجابية في هذا الأمر، إلا أننا نعرف – أنا وأنت – أنه لا زال هناك الكثير من التعيين المبني على المحاباة أولاً قبل الجدارة، أو في أفضل الأحوال يكون هناك تقييم – متواضع – للجدارات ولكنها ليست الجدارات التي يحتاجها المنصب، فمثلاً كم مرة شاهدت رئيسًا في قسم أو منشأة لديه معرفة تقنية مذهلة في القطاع لكنه لا يملك أدنى قدرة على إدارة المشاريع وقيادة الفرق…
ناهيك عن ضغوطات العمل وتوقعات القيادة التي تجعل أصحاب القرار يقومون بتعيينات سريعة وغير مدروسة لمجرد أنهم يريدون شخصًا “الآن الآن”، ويكفي أن يكون لديه “The Right Attitude” وبعض من الخبرات التي قد تكون مشابهه – ولو بشكل سطحي – للنطاق الذي استدعى من أجله، ليكتشفوا بعد أشهر قليلة أنه قرار خاطئ كلفهم أكثر بكثير من لو أنهم تريثوا في التعيين.
لو أن بيئات العمل رأت المنصب الإداري/القيادي – تحديدًا – على أنه سلاح، كونه سُلطة، لربما استشعرت وفهمت حقًا مدى القوة التي تمنحها للشخص الذي اختارته لهذا المنصب، فهمها كانت بيئة العمل “عبيطة” ولا تتبع ممارسات منهجية في عملها فهي بالتأكيد لن تسلم سلاحًا لشخص ليس أهلاً لحمله.
التعيين الإداري/القيادي بمعايير ابن النجوم والصحراء
السلاح ليس مجردة “قطعة تقتل”؛ تدافع أو تغزو بها، بل تجلٍّ لمصدر قوة، وأعتقد أن ما سحرني في القصة هو تفطّن «الخلاوي» لضرورة مصاحبة القوة لذهنية متيقظة ولمّاحة، وشخصية باحثة ومثابرة، وإلا لا يُستحق امتلاك القوة في ظل انعدام هذه السمات.
معرفة مخبأ السلاح تتطلب معرفة ضليعة باللغة لفهم اشارات الأبيات، تتطلب فهم للمحيط المكاني، ومعرفة بعلوم الفلك أو مواقع النجوم وتحركاتها (يمكن أن نعتبره العلم المطلوب في ذلك السياق الزماني والمكاني)، تتطلب نباهة عالية، تتطلب إصرار ومثابرة في البحث، كل هذه السمات شكلت معايير استحقاق القوة عند «الخلاوي».
التعيين للمنصب الإداري/القيادي لا يختلف كثيرًا، فالقوة التي تمنحها سلطة المنصب تحتاج إلى تمكن من اللغة والتي تتمثل في براعة التواصل مع الآخرين، سواء كان تواصلًا منطوقًا أومكتوبًا، وتحتاج إلى معرفة ملمة بحيثيات السياق التي تعمل فيه، تحتاج لذهنية لمّاحة ومتيقظة للإشارات من حولها، وتحتاج إلى مثابرة في البحث والفهم على روية تنقذ المشاريع والمخرجات من لعنة سرعة التنفيذ العمياء. (بالطبع توجد سمات أخرى مهمة لهذه المناصب مثل الذكاء الاجتماعي وامتلاك الرؤية..إلخ)
أعتقد أن هناك لبسًا دائم الحدوث عند تقييم المرشحين للمناصب الوظيفية، خاصة الإدارية/القيادية، ففي الغالب لا يوجد مرشح جاهز لمنصب ما بنسبة ١٠٠٪، دائمًا ما ستكون هناك مساحة للنمو والتمدد المهاري والمعرفي في أي منصب، وهذا طبيعي ومقبول، لكن أعتقد أن هذا النقص الطبيعي أو جزء عدم تمام الجاهزية دائمًا ما يتم خلطه مع فرضية خاطئة تقع فيها معظم الشركات والمنظمات بحسب دراسات غالوب – ألا وهي أن “كل إنسان يستطيع التعلم ليصبح ماهرًا في أي شيء تقريبًا”. إلا أن الحالتين مخلفتين تمامًا.
في الحالة الأولى توجد أهلية تتمثل في توفر الجدارات/المهارات المطلوبة وإن لم تكن بعد بالمستوى المطلوب، أما الحالة الثانية فلا يوجد لدى المرشح هذه الجدارات الأساسية تمامًا لكنه يُعتَقد بالضرورة أنها قابلة للتطوير إلى المستوى الذي يتطلبه المنصب، إلا أن ذلك ليس صحيحًا كما ناقشت في مقالة سابقة، ليس كل إنسان قادر على أن يكون بارعًا في التواصل، أو القيادة، أو التفكير الاستراتيجي..إلخ مهما تلقى من التدريب.
لذلك إن كنت في موضع اتخاذ قرارات تعيين، اسأل نفسك في المرة القادمة تختار فيها مرشحًا لمنصب ما: لو كان هذا المنصب سلاحًا، فهل يملك فلانًا المؤهلات التي تخوله لحمله واستخدامه؟.
— انتهى —
ملاحظة: يقول البعض أن قصة تخبئة السلاح غير حقيقية وإنما هي من نسج خيال الرواة..الله أعلم 🙂
مصدر صورة المقالة: fineartamerica.com
انضم إلى قائمة القرّاء حتى تصلك مقالات مثيرة من هذه الغرفة الصغيرة!
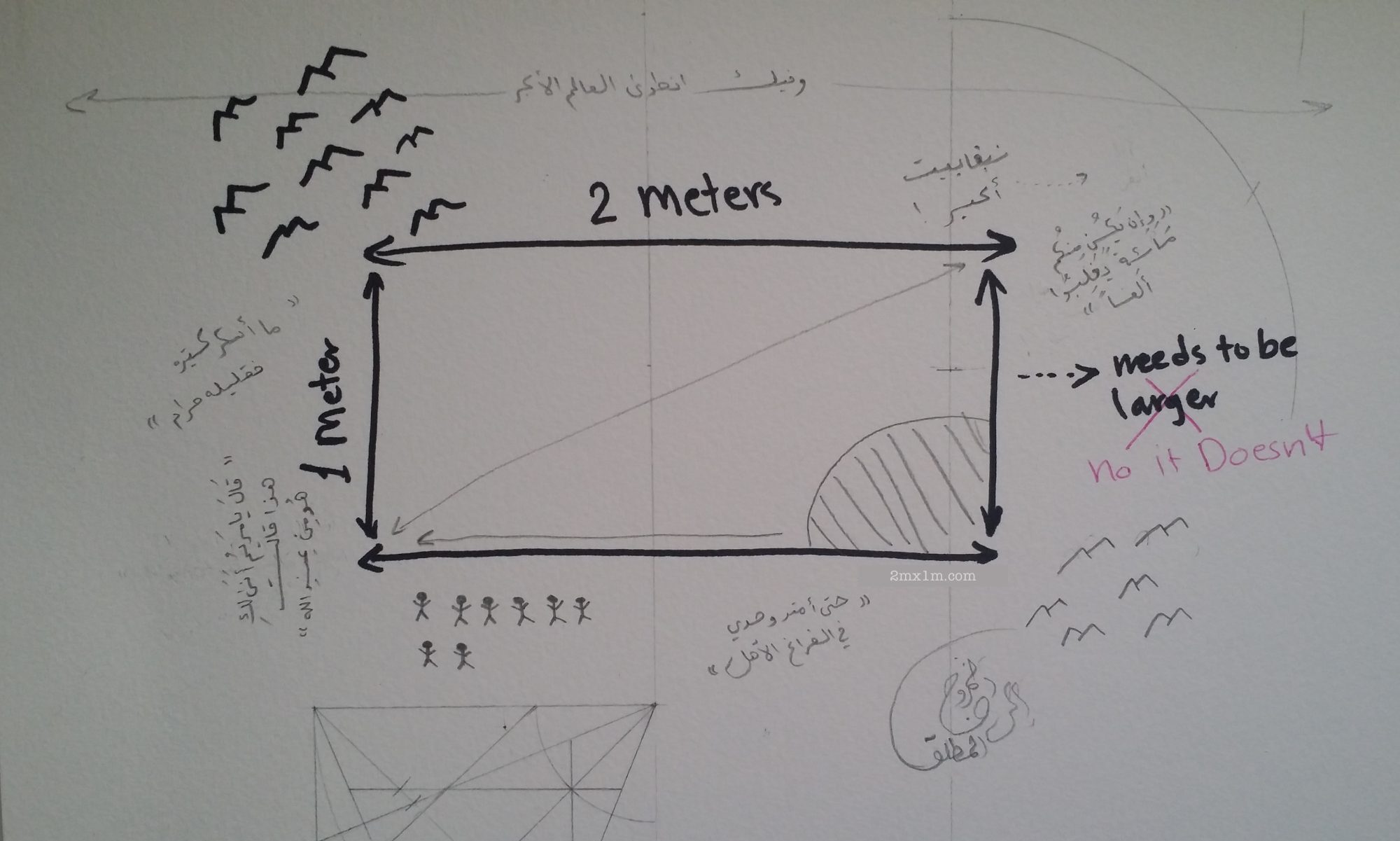

لفتني اسقاط القصة على حياتنا بهذا الشكل ٬مقال رائع كالعادة
“ قصة ملهمة” كثيرًا ما شاهدت ذو منصب ليس لديه ادنى مؤهلات تبوئه تلك المكانة ، ولكنها سياقات الحياة فيها من التناقضات ما يصعب حصرها، الا انه في نهاية المطاف لا يصح الا الصحيح ولغة الأرقام لا تعرف المواربة او المداهنة وفي ظني بان تلك الظاهرة بدأت في الانحسار والنضج المؤسسي مدفوع بالربحية والاستدامة، وهذان العاملين لا يمكن تحقيقهما من فراغ والصوت لا ينتقل في الفراغ.
دمتم بخير
ابو زين